 ادعمنا
ادعمنا
عانى المجتمع الأوروبي من أحداث سريعة مربكة بدءًا من الثورة الصناعية خلال القرن الثامن عشر حتى نهاية الحرب العالمية الأولى في مطلع القرن العشرين، وما نتج عن ذلك من تبدلات عميقة في شكل الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية ساهمت في تبلور نظام سياسي جديد يختلف كليًا عما عُرف سابقًا من أنظمة سياسية، ألا وهو النظام الشمولي.
وعلى الرغم من تشابه النظام الشمولي مع الأنظمة الاستبدادية والديكتاتورية في بعض السمات، إلا إنه يتفرد بقدرته على فرض سيطرته بشكل شامل وكلي على كل أبعاد الحياة الإنسانية، عامةً كانت أم خاصة. فما هو النظام الشمولي؟ وما الظروف التاريخية التي أدت إلى ظهور هذا النظام؟ وما السمات العامة للأنظمة الشمولية؟ وما الفرق بينها وبين النظام الاستبدادي؟
إن مصطلح الشمولية Totalitarianism مشتق من الكلمة اللاتينية Totalitas وتعني الوحدة والاتحاد أو الكل، أما في اللغة الإنجليزية، تعني Totalitarian الشامل والمطلق. أول من استعملها في السياق السياسي كان الرئيس الإيطالي موسوليني Benito Mussolini في خطابه الذي ألقاه في تشرين الأول 1925 حين قال "الكل في الدولة، ولا قيمة لشيء إنساني أو روحي خارج الدولة". بعدها قام الفيلسوف الإيطالي جيوفاني جينتل Giovanni Gentile ببلورة المفهوم فلسفيًا وسياسيًا في مقاله المعنون "الأسس الفلسفية للفاشية" الصادر عام 1928، ووظّف المصطلح بمعنى الإحاطة الشاملة للنظام الفاشي القائم على مبدأ "لا حدود ولا مكان لا يحق للدولة التدخل فيه". وكان استخدامه لمصطلح الشمولية للإشارة إلى هيكل الدولة الجديدة وأهدافها، حيث تطمح هذه الدولة إلى تحقيق وحدة عضوية بين المجتمع الإيطالي والنشاط الاقتصادي والحكومة؛ ولن تحقق الدولة الجديدة التمثيل الكامل للأمة فحسب، ولكنها ستمارس أيضًا التوجيه الكامل للأهداف الوطنية.
لا تشير الشمولية فقط إلى نظام سياسي، ولكنها أيضًا أيديولوجية سياسية فلسفية تعمل على توحيد أو تجميع الحياة العامة الدينية والاقتصادية والسياسية والفنية في نوع من أحادية على مستوى السلطة ورؤية العالم، وذلك باستعمال جميع الوسائل، بما فيها وسائل القمع والترهيب.
لقد افترض موسوليني وجينتل دولة شاملة تتمتع بسلطة أكبر من النظام الليبرالي القديم تسعى إلى تطوير موارد الشعب بأكمله وتحقيق التطلعات العليا للأمة، وهو طموح كان شائعًا في القرن العشرين.
وعلى الرغم من محاولة موسوليني وجينتل توضيح مصطلح الشمولية، إلا أنه ظل غامضًا إلى حد ما. تتابعت لاحقًا الدراسات والكتب حول الأنظمة الشمولية، فظهر -على سبيل المثال- كتاب فرانز بوركنو Franz Borkenau بعنوان "عداء الشمولية" عام 1940، حيث بيّن الطابع الشمولي للبلشفية والفاشية والنازية، واستعمله كذلك عالم الاجتماع الفرنسي مارسال موس Marcel Mauss في بداية العشرينيات من القرن الماضي، عندما ربط علم الاجتماع بالأنثروبولوجيا، واستخدم هذا النهج لتحليل ظاهرة الحرب، والعلاقة بين الحرب والمجتمع الناشئ في إطارها.
أخذ هذا المفهوم معاني جديدة في سياق الحرب الباردة بعد نهاية الحرب العالمية الثانية ، وساهم في ذلك مثقفون وعلماء اجتماع وسياسة وفلاسفة منهم -على وجه الخصوص- كارل بوبر Karl Popper وحنة أرندت Hannah Arendt ولاحقًا ميشيل فوكو Michel Foucault. إلا أن هذا المفهوم شهد خفوتًا في النصف الثاني من سبعينيات القرن العشرين، نتيجة لسياسة التعايش السلمي. ولكن ما إن سقط الاتحاد السوفييتي وتفكك المعسكر الاشتراكي في بداية التسعينيات، حتى عاد إلى واجهة التحليلات السياسية والفكرية. فقد ظهر في ألمانيا في كتابات مؤرخين أمثال أرنست نولت Ernst Nolte، وفي فرنسا في كتاب "تاريخ وهم" للمؤرخ والسياسي فرانسوا فريي Francois Furet و في كتاب ستيفان كورتوا Stéphane Courtois الذي حمل عنوان "الكتاب الأسود للشيوعية".
وقد استمر الحضور المكثف لمصطلح الشمولية، حيث يؤكد الزواوي بغورة أن المرء لا يكاد يتصفح جريدة عربية أو أجنبية، إلا ويلحظ ورود هذا المصطلح. ويعود ذلك -حسب رأي الزواوي- لأسباب كثيرة، أهمها سقوط المعسكر الاشتراكي وما تبعه من تنظير حول "ما بعد الأيديولوجيا"، و"نهاية التاريخ" والحديث المتزايد عن نظام عالمي جديد. لهذا يتكرر لفظ الشمولية لوصف بعض الأنظمة والعقائد التي لا تزال تتصل بطريقة أو بأخرى بالنظام السوفييتي السابق أو بالعقائد المماثلة له، خاصةً بعد أحداث 11 سبتمبر، والدعوة إلى مناهضة الإرهاب والعقائد الشمولية المساندة له. ولذلك وُصفت بعض الحركات الإسلامية السياسية بالشمولية.
كما ربط بعض الفلاسفة المعاصرين الشمولية بتفكك وفساد الديمقراطية المعاصرة مثلما فعل شيلدون ولين Sheldon Wolin عندما وصف النظام السياسي الأمريكي بـ "الشمولي المعكوس" Inverted Totalitarianism لدمجه أشكال السلطة، مثل الدين والاقتصاد والسلطة السياسية، التي كانت تعمل بشكل منفصل في بداية الحداثة الليبرالية؛ وقد رأى ولين أن هذا الاندماج يسمم الديمقراطية من جذورها. أما سلافوي جيجك Slavoj Žižek فقد ربط بين تفشي الشمولية والرأسمالية العالمية، فتحدث عن الرأسمالية الشمولية؛ ورأى في مصطلحات مثل حقوق الإنسان والديمقراطية وحكم القانون قناعًا خادعًا للآليات الشمولية، لأن الانسان المعاصر في واقع الأمر فقد آخر ذرّة من الاستقلال بانغماسه في الرأسمالية المتأخرة للعالم المُدار. في حين تحدث فريدريك وليام انجدال Frederick William Engdahl عن شمولية التكنوقراط ومدى تأثير سلطة كبار مصرفيّي وول ستريت وقدرتهم على التلاعب بالبشر والسيطرة على الإعلام والنظام السياسي والاقتصادي والتكنولوجي العالمي ككل.
تضرب فكرة "الشمولية" جذورها في السياق التاريخي للحرب العالمية الأولى، التي وصفت -قبل أن يشيع موسوليني وهتلر التعبير- بـ"الحرب الشاملة". ففي خضمّ هذه الحرب الشاملة وفي أعقابها مباشرةً، رأت النور التجارب التاريخية الثلاث التي كانت وراء ظهور مفهوم "الشمولية": الشيوعية الروسية والفاشية الإيطالية والنازية الألمانية. وعلى رغم الفروق الجوهرية ما بين هذه الأنظمة الأيديولوجية الثلاثة، فقد عّبرت جميعها عن أشكاٍل غير مسبوقة من شمولية السلطة وطغيانها على الدولة والمجتمع معًا.
تتحدث أرندت عن الأحداث التي أعقبت الحرب العالمية الأولى من ثورات وحركات وتهافت النظام البرلماني، ثم ظهور كل أنواع الاستبداد الجديدة، الفاشية منها وشبه الفاشية، وديكتاتوريات النظام الواحد والجيش، وآخرَ المطاف نشوء كيان صلب في ظاهرهِ من الأنظمة التي تعتمد على الجماهير، ومثال على ذلك صعود النظام النازي في ألمانيا عام 1933.
من جهته، يرى ستانلي جي. باين Stanley G. Payne في كتابه الذي حمل عنوان "الفاشية: المقارنة والتعريف" أن كارثة الحرب العالمية الأولى جرفت الكثير من أسس ليبرالية القرن التاسع عشر وفتحت حقبة من الثورة والصراع السياسي أكثر حدّة من أي وقت مضى. ويؤكد ستانلي أن الشيوعية الروسية -في ذلك الوقت- كانت إحدى القوى الثورية الرئيسية الجديدة، والتي تطورت مباشرةً من النظرية الماركسية الأوروبية للقرن التاسع عشر والنظرية الثورية الروسية. أما عن القوى الراديكالية الرئيسية الأخرى التي أطلقتها الحرب العالمية الأولى –كالفاشية – فقد كانت أكثر حداثة وأصالة، لأنها أتت نتاجًا مباشرًا للحرب نفسها، فلم يكن هناك حزب فاشي ولا عقيدة فاشية موجودة على هذا النحو قبل عام 1919. ومع ذلك، رفض اليسار الأوروبي الشيوعية إلى حد كبير، واقتصرت على روسيا كنظام. أما عن الفاشية الإيطالية -التي تأسست في عام 1919- فقد تبعتها حركات مشابهة إلى حد ما في العديد من الأراضي الأوروبية الأخرى، وعلى وجه التحديد في شرق ووسط أوروبا وفي إسبانيا بحلول ثلاثينيات القرن الماضي، لذلك يشير العديد من المؤرخين إلى حقبة ما قبل الحرب العالمية الثانية بأكملها باعتبارها الحقبة الفاشية في أوروبا.
غالبًا ما يُقال إن الأفكار الفلسفية الفاشية تنبع من معارضة التنوير أو "أفكار 1789"، أو أنها نتاج ثانوي مباشر لجوانب التنوير ومشتقة تحديدًا من المفاهيم العلمانية الحديثة للقرن الثامن عشر. ولكن الاختلاف الأساسي للأفكار الفاشية عن جوانب معينة من الثقافة الحديثة يكمن على الأرجح في تأكيدها على الحيوية الفلسفية والمثالية وميتافيزيقيا الإرادة؛ حيث كانت الثقافة الفاشية -على عكس ثقافة اليمين- علمانية في معظم حالاتها، ولكنها بخلاف ثقافة اليسار -وعلى وجه التحديد الليبراليين- قامت على الحيوية والمثالية ورفض حتمية ماركس الاقتصادية. والهدف من المثالية الميتافيزيقية والحيوية هو خلق رجل جديد، وأسلوب جديد للثقافة يحقق التميز الجسدي والفني، ويقدّر الشجاعة والجرأة والتغلب على الحدود الموضوعة مسبقًا حول نمو ثقافة جديدة متفوقة.
كان الفاشيون يأملون استعادة المعنى الحقيقي للطبيعة البشرية -وهي فكرة من القرن الثامن عشر أساسًا- من حيث كونها أكثر مثاليةً وثباتًا من الثقافة الاختزالية للمادية الحديثة والأنانية التحوطية. سيكون الإنسان الطبيعي الحر ذو الإرادة والتصميم قادرًا على تجاوز القيمة والذهاب إلى أبعد من ذاته، ولن يتردد في التضحية بنفسه من أجل تلك المُثُل. وقد مثلوا محاولة لتحقيق شكل حديث إلحادي من الترنسندنتالية، لا ينتمي بصلة إلى القيم الأخلاقية والروحية التقليدية للعالم الغربي.
إن الهشاشة الثقافية ونسبية القيم الأخلاقية الأوروبية منذ أواخر القرن التاسع عشر فصاعدًا، جنبًا إلى جنب مع ما أدت إليه الحرب العالمية الأولى من تداعيات مثل الاضطرابات الاقتصادية الشديدة والصراع الاجتماعي والشذوذ الثقافي، نتج عنه نوع من الانهيار الروحي الذي سمح لأشكال جديدة من القومية الراديكالية بالازدهار، تعيد توكيد الدولة بوصفها الماهية الحقيقية للفرد. فلا حرّية إلا للدولة، ولا حرّية للفرد إلا في الدولة. ولهذا فإن الكل في الدولة، ولا شيء مما هو إنساني أو أخلاقي يمكن أن يوجد خارج الدولة. وبذلك يرى أصحاب المذهب الشمولي أنه ليس هناك شيء آخر سوى سيادة هذا "الكل" الذي من دونه يكون باقي الوجود "لا شيء".
يعتبر كارل فريدريك Carl Friedrich أول كاتب له السبق في تحديد المعالم الكبرى للشمولية، وقد بين ذلك في أربع نقاط أساسية وهي:
1- الاعتماد على أيديولوجية تنبّؤية، تحتكم إلى شكل من أشكال فلسفة التاريخ.
2- الاعتماد على الحزب الجماهيري الواحد.
3- احتكار وسائل الإعلام.
4- الرقابة البوليسية العنيفة.
ولقد استعمل العديد من علماء الاجتماع هذا النموذج لوصف وتحليل النظم الشمولية، ومنهم عالم الاجتماع الفرنسي ريمون أرون Raymond Aron في كتابه "الديمقراطية والشمولية" 1965، وتبعه في ذلك كلود لوفور Claude Lefort وكلونيلوس كاسترياديس Cornelius Castoriadis وغيرهم.
إن الأيديولوجيا هي منطق فكرة ما، وموضوعها هو التاريخ الذي انطبقت "الفكرة" عليه. والواقع أن الأيديولوجيا تعالج ترابط الأحداث وكأنه يخضع لنفس "القانون" الذي يحكم "فكرتها". وإذا كانت الأيديولوجيا تزعم معرفة خفايا التقدم التاريخي برمته، وأسرار الماضي، ومتاهات الحاضر، وشكوك المستقبل، فذلك بسبب المنطق الذي لازم أفكارها المتوالية. وعليه فإن الأيديولوجيات لا تهتم بالكينونة، إنما تهتم بالصيرورة وشرح التاريخ من خلال "قانون طبيعي" ما.
لقد ارتبطت الأيديولوجيا ومحاولة البحث عن منطق ارتباطًا وثيقًا ”بالاقتلاع - Uprootedness“ وانعدام الجدوى اللذين أصابا الجماهير المعاصرة منذ بدء الثورة الصناعية، وصارا إلى موضع حرج بصعود الإمبريالية في آخر القرن التاسع عشر، وتفكك المؤسسات السياسية والتقاليد الاجتماعية في القرن العشرين، فأصبحا بمثابة داعمين في عالم بات لا يثق فيه المرء بأحد ولا يسعه الاعتماد على شيء.
في هذا الصدد اتُّخذت الأنظمة الشمولية العرقية أو الشيوعية كأيديولوجيتين لتفسير الماضي تفسيرًا شاملًا، ومعرفة الحاضر معرفة كلية، والتنبؤ بالمستقبل على نحو معين. على سبيل المثال، اعتبرت النازية صراع الأعراق قانون الطبيعة والسبيل الوحيد لتفسير كل الأحداث التاريخية. وهذا ما جعل بعض الفلاسفة مثل بوبر يؤكدون أن الطابع الشمولي الذي تتسم به العقائد السياسية للفاشية والشيوعية نابع من فلسفتها في التاريخ لا في السياسة، فالفلسفات الشمولية ما هي إلا استجابة لتلك المقولة التي تفرض علينا أن نبدأ منذ الآن بصياغة حياتنا طبقًا لمقتضيات المرحلة المستقبلية، ما دامت هي آتية لا ريب فيها، وبهذا نكون متسقين مع "المنطق الحتمي للتاريخ".
لقد رسخت الحركات الشمولية الإيمان التام بأن صراع الكل ضد الكل إنما هو مبدأ الكون، وأن التوسع (الاستعماري) هو ضرورة نفسية قبل أن يكون وسيلة سياسية، وأن الإنسان ينبغي لَهُ أن ينقاد وفق قوانين كونية مماثلة. كما أثارت الغرائز المعادية للإنسانية والمعادية لليبراليين وللفردانيين وللمثقفين، فانبرى جيل الحرب والجبهة يمدح العنف مدحًا طنانًا وروحيًا، ويعلي من شأن القوة والقساوة إلى مصاف الفضيلة الأصلية لكونها تناقض الخبث الليبرالي.
والحال أن هذه الأنظمة كانت على قناعة تامة بأن صياغة التاريخ التقليدية ما هي إلا تزييف محض. لذلك فقد تبنت التلقين الأيديولوجي الذي ينظم الوقائع وفق إجراء منطقي ومتماسك تمامًا، ينطلق من فكرة أولية ويسوغ لنفسه أن يستنتج الباقي.
وفقًا لذلك ترى أرندت أن الأنظمة الشمولية ربطت بين الطبيعة والتاريخ والإرهاب، وذلك عندما ادّعى الحزب ضرورة قيامه ببعض الجرائم لكونه أعلم الناس بقانون الطبيعة وبصيرورة التاريخ وأجدرهم معرفة بمن ينبغي معاقبته. ذلك أن التاريخ يستحيل أن يتقدم دون معاقبة كل من يعوق مسيره.
اعتبر هتلر تعدد الأحزاب السياسية لا يفيد الدولة بشيء، لأنها فقط تحاول التعاون مع المؤسسات القائمة طمعًا في الحصول على نصيب بسيط من الغنيمة، فيقف كفاحها عند هذا الحد. لذلك غالبًا ما تسعى الحركات الشمولية إلى تنظيم الجماهير وتفلح في ذلك - بخلافِ الأحزاب القديمة القائمة على المصالح والتي تهتم بالطبقات، وبالمواطنين ذوي المصالح، وبتأثير الآراء العامة في مسار الشؤون المحلية. وإذا كانت كل الجماعات السياسية تُنسب إلى مراكز قوى نسبية في المجتمع، فإن الحركات الشمولية تتبع قوة الأعداد وحدها.
ترى حنة أرندت أن الشمولية اجتذبت غالبية الشرائح العريضة من الناس الحياديين، واللامبالين سياسيًا، والذين كانوا موضع رفض من الأحزاب الأخرى، لاعتبارهم غاية في البلادة أو الحماقة. وكانت النتيجة أن غالبية المنتسبين إليها أناس لم يتسنَّ لهم الظهور على الساحة السياسية من قبل، مما سمح بإدخال مناهج للدعاية السياسية جديدة كليًا، وسوّغ اللامبالاة إزاء حجج المعارضين. ونشأ عن ذلك أن هذه الحركات لم تجد نفسها خارج نسق الأحزاب ورافضة إياها بالجملة فحسب، بل إنها اهتدت إلى زبائن كثيرين أيضًا لم يكن نظام الأحزاب قد مسّهم أو أفسدهم على الإطلاق. لذا لم تحتج الحركات الشمولية إلى دحض الحجج التي كان المعارضون يوجهونها إليها، بل آثرت استخدام التهديدات بالموت والإرهاب كبديل للإقناع. ومضَتْ تزعم أن الخلافات إنما تنشأ من مصادر عميقة، وطبيعية، وتستمد من جذور اجتماعية أو نفسية تكون عصية على المنطق.
وتؤكد أرندت أن هذا الأمر كان يمكن أن يُضاعف عدد المنتمين لو أن الحركات الشمولية رضيت بالمنافسة الصادقة مع غيرها من الأحزاب؛ كما أن الأمر عينه كان يمكن أن يصير قوة لو أنها كانت واثقة في تعاملها مع أناس كان لهم من الأسباب ما يجعلهم معادين لكلِّ الأحزاب.
إن اللامبالاة إزاء الشؤون العامة والحياد في المجال السياسي، ليسا شرطين كافيين لنمو الحركات الشمولية. ولقد أثار المجتمع البورجوازي -القائم على المنافسة والتملك- البلادة وحتى العداء إزاء الحياة العامة، ليس في نفوس الطبقات الاجتماعية التي راح يستغلها، والتي لم يكتفِ باستبعادها من المشاركة الفعالة في إدارة البلاد فحسب، بل وفي نفوس أبناء الطبقة البورجوازية أيضًا. وقد أعقب حقبة التواضع من قبل الطبقة البورجوازية -والتي اكتفت بكونها الطبقة السائدة من دون أن تطمح إلى الحكم السياسي الذي تركته طوعًا للطبقة الأرستقراطية- عهد الامبريالية، والذي راحت البورجوازية تعلن فيه عداءَها للمؤسسات الموجودة، وشرعت في تنظيم نفسها مطالبة بممارسة السلطة السياسية.
لما كان النظام الحزبي قائمًا على المصالح الطبقية، فقد وجد هؤلاء أنفسهم بلا حزب يهتم بمصالحهم الخاصة، كما لم يكن لهذه الأغلبيات أي قاسم مشترك في ما بينها؛ وسرعان ما تضخم جمهور اليائسين بعد الحرب العالمية الأولى في ظل البطالة والتضخم وتصدع المجتمع عقب الهزيمة العسكرية. ووسط انهيار نظام الطبقات وتنامي نفسية "رجل الجمهور"، انهار نظام الأحزاب نفسه؛ وراحت الجماهير تتنامى انطلاقًا من شرائح مجتمع شديد التفتت لا يلحم أجزاءه إلا الشعور الوطني المتشدد المتسم بالعنف والذي انقاد إليه زعماء الجماهير، لأسباب ديماجوجية محضة. هنا لم يستشعر الفرد نفعه إلا من خلال انتمائه إلى حركة أو حزب يدين له بالولاء اللامحدود، وغير المشروط، وغير المتبدل.
لذلك ترى أرندت أن الشمولية -على عكس ما تزعمه- تعتمد على الرعاع والحشد لا على الجماهير والمواطنين. من هنا فإن طبيعتها تتمثل في رفضها للعمل السياسي للمواطنين، فهي تعمد إلى تفتيت المجتمع أو "تذريره" Atomisation، وإلى المحو التدريجي للرأي العام. ومن هنا تعتبر أرندت الشمولية نفيًا كاملًا وشاملًا لما هو سياسي، لذا فإن المفارقة الكبرى للشمولية كنظام سياسي أنه نظام يتنافى مع العمل السياسي.
تجدر الإشارة إلى أن الحزب والدولة -في ظل النظام الشمولي- مصدران للسلطة لا يمكن الفصل بينهما. والعلاقات بين مصدري السلطة -الدولة والحزب- إنما كانت تنم عن سلطة ظاهرة وسلطة واقعية؛ بحيث يوصف الجهاز الحكومي عمومًا على أنه الواجهة التي تتوارى خلفها السلطة الواقعية التي يمارسها الحزب وتشكل حماية لها. كما أن جميع مهام الآلة الإدارية على كل مستوياتها تُوكل إلى أعضاء الحزب، والشخصيات المرموقة من الحزب تحتل وزارات الدولة الرسمية.
يقول هتلر إن "الدعاية على جانب عظيم من الأهمية، فهي أداة لتنوير الأذهان من جهة ولخداع من يراد خداعهم من جهة ثانية". واعتبر هتلر الدعاية فنًا فعالًا أغفل خطره القادة على الرغم من علمهم بمدى تأثيره في معنويات الجيش والشعب. كما تهدف الدعاية إلى لفت نظر الجمهور إلى وقائع وأحداث، لا إلى تنوير الشعب على أساس علمي، فتعمل على نشر فكرة ما بين الشعب كله واجتذاب الناس. واعتبر هتلر مسؤوليته عن تنظيم الدعاية للحزب تتعدى التنظيم والاشراف من الناحية الإدارية، إلى نشر أفكار الحزب، فالدعاية يجب أن تسبق التنظيم لتجمع حول الفكرة أكبر عدد ممكن من الناس.
تقوم الدعاية بنشر مبادئ أي حركة ذات أهداف انقلابية وتشرحها وترسخها في عقول الناس، أو على الأقل تسعى لزعزعة العقائد القديمة. وقد أكدت أرندت أن ما يميز الشمولية هو اعتمادها على الدعاية بشكل مطلق؛ من هنا كانت علاقة النخبة بالرعاع من خلال الدعاية المقرونة بالعنف، والتلقين الإجباري وغسيل الأدمغة، وشرعت في استخدام العنف لتحقيق عقائدها الأيديولوجية وإثبات مزاعمها التطبيقية. لذلك يتلازم الإرهاب والحملة الدعائية، حتى لَيكونا وجهين لعملة واحدة. يقول هتلر "إن الإرهاب لا يسحقه إلا الإرهاب. وإن فكرتنا لن تنتشر ما لم تدعمها القوة وتوفر لها الحماية اللازمة".
وإذا كانت الحملة الدعائية جزءًا لا يتجزأ من الحرب النفسية، فإن الإرهاب شأن آخر. إذ تلبث الأنظمة الشمولية تمارسه حتى بعد أن تكون بلغت أهدافها النفسية: فرعبُ الإرهاب الحق هو أنه يسود مواطنين ران عليهم الخضوع التام. وحيث بلغت سيادة الإرهاب حدها الأمثل، كما هي الحال في معسكرات الاعتقال، تلاشت الحملة الدعائية كليًا. بعبارة أخرى، لا تعدو الحملة الدعائية كونها إحدى أهم الوسائل التي تستخدمها الشمولية ضد العالم غير الشمولي، أما الإرهاب فهو ما يشكل هيئة النظام.
تكمن قوة الحملة الدعائية الشمولية في قدرتها المتعاظمة على قطع الصلة ما بين الجماهير والعالم الواقعي، وذلك قبل أن تمتلك الحركات الشمولية السلطة لإسدال ستار من حديد بغية الحيلولة دون أن يعكر أحد، ولو بنتفة من واقعيته، هدأة عالم متخيَّل تمامًا. هنا يقوم الإرهاب بدعم الإيهامات المزعومة. وما يميّز هذا العالم المتوهَم هو صرامة تنظيمه التي من شأنها أن توفّر الحس بالبقاء، في مقابل عالم حقيقي عديم المنطق وغير متجانس وغير منظَّم.
إن ذراع النظام الشمولي المدنية لم تكن الحزب، بل الشرطة، والتي كانت تحركاتها خارجة عن نطاق الحزب. فقد عمدت الشرطة إلى تصفية ملايين الأبرياء مطلقةً عليهم صفة "الأعداء الموضوعيين"، ممن اعتبرهم النظام "مجرمين" دون أن يرتكبوا جريمة، سوى كونهم أعداء للحزب (وتقصد أرندت بذلك كل من يعوق مسيرة التاريخ وفقًا للأيديولوجية المعتمدة في الدولة). ولا يتوقف الأمر عند تصفية المعارضة أو دعاة التخريب -من وجهة نظرهم- إنما تتجسس الشرطة السرية أيضًا على أعضاء الحزب وعلى الأعضاء العاملين العاديين.
تقول أرندت "إن سيادة الشرطة السرية على الجهاز العسكري هي إحدى سمات أنظمة الاستبداد العديدة، وليست ما يختص به النظام الشمولي دون غيره. ومع ذلك فإن رجحان سلطة الشرطة لا يتجاوب مع حاجة النظام الشمولي إلى إلغاء السكان المحليين فحسب، بل يتلاءم مع الزعم الأيديولوجي بالسيادة على الكوكب بأسره أيضًا. فمن البداهة أن الذين يعتبرون الأرض بأسرها أرض طموحهم المستقبلي سوف يشددون على عنصر العنف الداخلي ويحكمون الأراضي المفتتحة بوسائل بوليسية وعبر أشخاص منتمين إلى الشرطة، أكثر من كونهم في الجيش". وهكذا تم للنازيين -على سبيل المثال- أن يستخدموا فرقهم الخاصة مثل فرقة "حماية ومراتب" (.S.S) التي كانت قوة كبيرة مؤلفة من الشرطة الألمانية، من أجل إدارة الأراضي المفتتحة في الخارج ومن أجل غاية تقضي بدمج الجيش بالشرطة تحت قيادة واحدة في يد هذه الفرقة، أي (S.S.).
إذا تابعنا تصنيفات الفلاسفة اليونان أمثال أفلاطون، نجد أنفسنا منساقين إلى تأويل الشمولية على أنها شكل معاصر من أشكال الاستبداد، ونعني به نظامًا دون قوانين، حيث السلطة يحتكرها رجل واحد. إن اعتباطية السلطةـ وتجاوزها القوانين، وممارستها لصالح الحاكم، والخوف باعتباره مبدأ عمل -الخوف الذي يستشعره الحاكم من الشعب، والخوف من الحاكم الذي يستشعره الشعب من جهة أخرى-، تلك السمات التي لطالما انطبع بها الحكم الاستبدادي جعلت التصنيف التقليدي للأنظمة في الفلسفة السياسية يقوم على الحديث عن نظام من دون قوانين، أو نظام خاضع للقوانين، وعن سلطة شرعية أو سلطة اعتباطية؛ ولكن أن يكون هناك نظام خاضع لقوانين وسلطة شرعية من جهة، وأن يكون ثمة غياب للقوانين وسلطة اعتباطية من جهة أخرى، أي أن تتعايش جوانب هذا الواقع كلها في آن معًا حتى لتصير عصية على الفصل، فهذا ما لم يكن بالحسبان على الإطلاق. وهذا -كما تقول أرندت- ما يجعلنا نتحدث عن الحكم الشمولي كنوع من الحكم مختلف تمامًا.
إن النظام الشمولي لم يقدم على تصرفاته إلا مسترشدًا بالقانون، ولم يكن اعتباطيًا قط؛ إذ إنه لطالما ادّعى إطاعة قوانين الطبيعة والتاريخ طاعةً صارمة ودون أي لبس، بحكم أن كل قوانينه الوضعية إنما هي مستمَدّة منهما دومًا؛ ولكنه ما لبث أن تصدّى لكل القوانين التي أصدرها بنفسه. بعبارة أخرى تتجاوز الشمولية كل "توافق تشريعي"، دون أن تخضع لغياب القوانين، وللاعتباطية والخوف اللذين يميزان دولة الاستبداد. فإذا كانت الشرعية جوهر النظام غير الاستبدادي، وغياب القوانين جوهر الاستبداد، فإن الإرهاب أحرى ما يكون جوهر السيطرة الشمولية.
لذلك يرى محمود حيدر أن مفهوم الدولة الشمولية يضّم مجملًا للمفاهيم التي تدّل على الدول ذات الحكم الاستبدادي، مثل الفاشية، وحكم الزعيم الفرد، والملَكية المطلقة، وسواها. كما تشير «الدولة الشمولية» إلى بنية مؤسساتية وإلى مجموعٍة من الممارسات المنتظمة حول توسع التدّخل السياسي ليشمل الحقل الاجتماعي برمّته؛ فهي تعني شكًلا عامًا للهيمنة الكلية على السكان والأفراد وأنشطتهم، وعلى الممارسات الاقتصادية والثقافية التي غالبًا ما نتعّرف على قوّتها البارزة، من خلال نتائجها التاريخية والإنسانية والاجتماعية، في كل من النازية والستالينية، وإلى حدّ ما، الفاشية الإيطالية.
تتّحد جميع هذه النماذج في طابعها القومي العنصري، والاستبدادي الرافض للتعددية والديمقراطية، وإلغاء الحريات السياسية والنقابية وحرية التنظيم إلغاءً تامًا خارج الأطر التي تضعها هي وتراقبها. وعليه يُعَدّ الاستبداد الكلي هو شكل النظام الشمولي الوحيد، الذي يصير معه أي تعايش محالًا. إنها السلطة المطلقة القائمة على "عبادة الشخصية"، واحتكار أدوات العنف، وسيادة الشرطة السرية على الجهاز العسكري.
بناءً على ذلك وجد جوان لينز Juan J. Linz أن النظام الشمولي يتضمن عناصر جديدة لا تغطيها الكلمات القديمة كالديكتاتورية وغيرها. تتمثل هذه العناصر في ست سمات وهي: (١) أيديولوجية شمولية، و(٢) حزب واحد ملتزم بهذه الأيديولوجية ويقوده عادة رجل واحد وهو الدكتاتور، و(٣) شرطة سرية. أما السمات الثلاثة الأخرى فهي ثلاثة أنواع من الاحتكار أو السيطرة الاحتكارية وبالتحديد على (أ) الدعاية، (ب) الأسلحة، (ج) جميع المنظمات بما في ذلك المنظمات الاقتصادية. ويمكن تجميع هذه السمات الست في ثلاث سمات فقط وهي: أيديولوجية شمولية، وحزب تعززه شرطة سرية، واحتكار الأشكال الثلاثة الرئيسية للمواجهة في المجتمع.
في هذا الصدد تؤكد أرندت أن الديكتاتورية العسكرية والنظام الاستبدادي لا يمكن اعتبارهما أنظمة شمولية على الرغم من تأكيدهما معًا على "مبدأ القائد". والسبب أن النظامين الديكتاتوري العسكري والاستبدادي يقومان على التراتبية والتسلسل في القيادة، لذلك فهما أقل شمولية، حيث تكون السلطة المطلقة من أعلى إلى أسفل، والطاعة المطلقة من أسفل إلى أعلى، مرتبطين ارتباط تلازم مع درجة الخطر القصوى التي يستشعرها البلد المعني. وعلى هذا تقوم كل تراتبية، مهما كانت استبدادية، بدورها، وكل تسلسل في القيادة مهما كان اعتباطيًا وديكتاتوريًا ينفذ محتوى من الأوامر لإشاعة الاستقرار؛ كل هذا يحد من السلطة الشاملة التي تُعطى لقائد الحركة الشمولية.
إن ما يميز النظام الشمولي هو غياب كل سلطة أو تراتبية؛ وهذا ما يتجلى -بصورة أخص- في غياب المستويات الوسيطة المسؤولة بين القائد الأعلى (الفوهرر) وبين المحكومين، والتي من شأنها أن تمنح كلًّا حصته من السلطة والخضوع.
كما أن الشمولية ما أن تتسلق سدة السلطة، حتى تشكل مؤسسات سياسية جديدةً كليًا، بعد أن تكون قد دمرت كل التقاليد الاجتماعية والتشريعية والسياسية القائمة في البلاد. فإذا كانت العزلة والعجز -أي عدم القدرة الأساسية والمطلقة على الفعل- خاصّتي الأنظمة الاستبدادية على الدوام، فإن أرندت ترى أن النظام الاستبدادي ما كان ليقضي على كل الصلات بين الناس، ولا كان ليحطّم كل الاستعدادات البشرية؛ وعلى هذا فقد ظلت كل دوائر الحياة الخاصة مع إمكانيات اختبار تجارب جديدة، والاختراع، والتفكير، محفوظة بشكل تام. في المقابل فإن الأنظمة الشمولية لا تترك مدى لأية حياة خاصة، والإكراه الذي ينطوي عليه المنطق الشمولي يقضي على ملَكة الاختبار والتفكر لدى الفرد. ولا يتعلق ذلك بتدمير طاقات الناس السياسية فحسب، بل تسعى الشمولية إلى القضاء على الحياة العامة والخاصة على السواء. وهذا أشد اختبارات الإنسان يأسًا وتطرفًا.
ادولف هتلر، كفاحي، منشورات المكتبة الأهلية، بيروت، ٢٠١١.
الزواوي بغورة، الشمولية والحرية في الفلسفة السياسية المعاصرة، عالم الفكر، العدد ٣، المجلد ٣٣، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، ٢٠٠٥.
حنة أرندت، أسس التوتاليتارية، ترجمة: انطوان ابو زيد، دار الساقي، ط٢، بيروت، لبنان، ٢٠١٦.
محمود حيدر، الدولة فلسفتها وتاريخها من الإغريق إلى ما بعد الحداثة ، المركز الإسلامي للدراسات الاستراتيجية (العتبة العباسية المقدسة)، ط١، ٢٠١٨.
نسيبة مزواد، الهيمنة التوتاليتارية في فكر حنة أرندت؛ خديجة زتيلي (إشراف)، الفلسفة السياسية المعاصرة (قضايا واشكاليات)، منشورات الضفاف، دار الأمان، منشورات الاختلاف، ط١، بيروت، الرباط، الجزائر، ٢٠١٤.
Chris Hedges, Sheldon Wolin and Inverted Totalitarianism, TRUTHDIG, NOV 2, 2015, 8/4/2023.
F. William Engdahl, Gods of Money “Wall Street and the Death of the American Century”, Edition.Engdahl, USA, 2009.
Juan J. Linz, Totalitarian and Authoritarian Regimes, Lynne Rienner Publishers, Colorado, London, 2000.
Nadia Urbinati: Reviewed Work(s): Democracy Incorporated: Managed Democracy and the Specter of Inverted Totalitarianism by Sheldon S. Wolin, Political Science Quarterly, Vol. 125, No. 1 (2010).
Stanley G. Payne, Fascism “Comparison and Definition”, The University of Wisconsin Press, Wisconsin, London, 1980.
Slavoj Zizek, Welcome to the Desert of the Real “Five Essays on September 11 and Related Dates”, VERSO, New York, London, 2002.
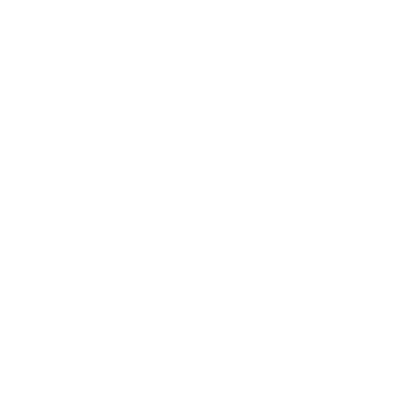
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.